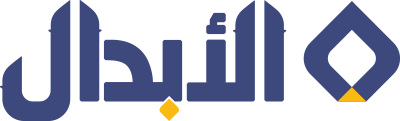“السجن” نعمة.. لماذا الهروب؟

لا يعرف الإنسان الحياة بشكلٍ جيّد إلا عند مروره بالتجارب، والسجن واحدٌ من هذه المنعطفات، لا يمكن له إلا أن يصنعك، ويضيف إليك الكثير، تُقَدّم لك نموذجاً سيئاً، أو نموذجاً صالحاً. وما لم تدخله، تبقى هناك طبقة ناقصة من طبقات نظرتك إلى الأشياء. أفقٌ واحدٌ ومتعدّد في نفس الوقت نائمٌ في قلبك، لا يوقظه سوى السجن.
في السجن، يبدأ امتحانك من فقدانك لخصوصيّتك، سيكون من الواجب عليك أن تتحمّل الرفاق قبل الجلاوزة، وأن تشاركهم كل شيء، حتى أمزجتهم، وأن تحترف الصبر، كما أنّ عليك أن تتعلّم فنون المداراة، وأن تكون ذا خبرةٍ في أنواع الشخصيّات، فليس الجميع سواسية، ولا كلّهم يفكّرون بنفس الطريقة.
هذا هو السجن، برجٌ لإطلالةٍ لا يمكن أن تُرى من أي مكانٍ آخر، تقييمٌ للماضي، واستشرافٌ للمستقبل، وتحديدٌ للمصير، وما لم يكن كذلك، فلا بد أنّه لا يعوّل عليه!
أمّا فطرتك، تلك التي جُبِلَت على الحريّة، فلا غرو أن تحدّثها بالهروب، لستَ شيئاً كُتب عليه أن يموت هنا، وإنما عليك أن تحفر في الصخر، وأن لا يستسلم قلبك فيهبط إلى حيث أرادوا، عليه أن يبقى محلّقاً في السماء، ولا يرضخ للظروف.
هكذا كنت أحاول أن أقنع أحد زملائي بالهرب، كان يراني أركض في باحة السجن ضاماً يداي في صدري أو إلى الخلف، سألني ذات مرّة: لماذا تركض بهذه الطريقة؟ ولا أظنّ أنّ فطنته خانته لتوقّع الأمر، أفصحت له عن سرّي، لم يتفاجأ، بدا متسمّراً مثل خشبةٍ يأخذها ماء البحر إلى أين يشاء، كأنّه يسترخي، ولكن لماذا لا تهرب من داخل السجن؟ سألني مرّة أخرى، قلت إنّه أحد الخيارات، وأنّني اخترت مسجد العنبر لهذا الأمر، سأقصُّ قضبان النافذة بمنشار سأهرّبه، وسأخرج.
وكان زميلي هذا قد ساعدني بتسلق ظهره يوميّاً في الباحة لمراقبة ما يجري في الخارج، أعدادُ الشرطة، تحرّكاتهم، وكيف سأمرّ. كنت أُقنِعُه أن يهرب معي، إلّا أنّه كان يعتقد أنّه سيُحكم له بالبراءة، كنت أضحك من كلامه هذا، أقول له بلهجة لطيفة: «لا أحد يخرج براءة!».
لا بدّ أنّ الحريّة هي التطلع الأول لأيّ سجين، لذا فإنّ الهرب ومحاولة التحرّر مسألة فطريّة أيضاً، إنّما الظروف المحيطة هي التي تجعل السجين يائساً من الأمر، الثكنات والكاميرات والانتشار الأمني المكثف، الحيطان الشاهقة والمتاريس! يبدأ السجن مثل صدمة، ثم يصير مثل الجرعات اليوميّة، ثم يصبح في داخلك، وإذا ما تسللت القيود إلى الداخل فهذا يعني أنك صرت سجيناً.
وفي لحظات التأمل الأولى، لحظات انكشاف الغطاء عن العين، يصبح السجن صومعة تأمُّل، فتذهَل، هذا هو الجانب الإيجابي في الأمر، فجأةً تراجع أخطاءك التي ارتكبتها منذ سنوات، مع نفسك وأهلك وأصدقائك والآخرين، يصبح الشريط واضحاً بعد أن كان ضبابياً قبل ذلك، فيعمل بشكلٍ جيّد!
كنت أحياناً أصل إلى قناعة، أنّ الأجيال بحاجة دائماً إلى السجن، لكي يتطوّر وعيها، وتبرأ من الاتكاليّة وتخرج من شرنقتها، تماماً مثلما تكون خلوة الأنبياء والأولياء والصالحين مع أنفسهم، تماماً مثلما تحثّ الكتب الأخلاقيّة على انتهاج هذه الآلية بين فترة وأخرى لتربية النفس، ليس هذا فقط، فقد كنت أقول في سرّي أنني عندما أصبح وزيراً للداخليّة في الحكومة المنتخبة فإنني سأخصّصُ سجناً لهذا الأمر، يشبه التجنيد الإجباري، فتمرّ الأجيال من هنا، لتعرف قيماً كثيرة، وتنتبه إلى النِعم التي تحيط بها.
هذا عندما يكون السجين سليماً من آفات النفس وصراعاتها وقوياً في حوار أحاديثها التي لا تنتهي، مؤمناً أنّ الظلم والعذاب وإن حلّا في حياته، فهما أمران نسبيان، وفيهما حكمة، وإلا فإنّ السجن لكثيرين مثل انهيارٍ شامل، يبقى الإيمان عندهم شكلاً، أمّا قلوبهم فكافرة ناكرة ساخطة!
أمّا الهروب، فليس هروباً من هذا الأمر، إنما طاقة صنعها السجن نفسه، لكسر هذا الظلم الذي صار روتيناً في حياة الشعب.
كنت قد اتفقت مع أحد السجناء لتهريب بعض الأدوات التي أحتاجها، مقابل إعطائه هاتفاً، وصلتني المنشار، وصرت أشكّل في بالي خطّة الهرب، إلّا أنّ شيئاً آخر حدث!
- الفصل السادس والعشرون من كتاب وطن عكر