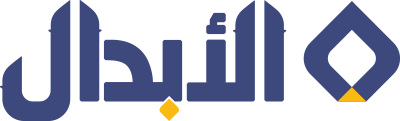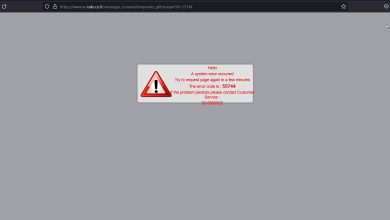تداعيات التغييرات الدستورية على النظام السياسي الإسرائيلي

- مقدمة
- أوّلًا: تفاقُم الأزمة السياسية واستمرارها
- (ثانيًا) انهيار الكيان المؤقت يبدأ من الداخل
- انهيار المؤسسة العسكرية: ازدياد ظاهرة الفرار من الخدمة العسكرية
- سقوط نظرية الامن الإسرائيلية
- زيادة معدلات العلمنة والعولمة والسعار الاستهلاكي في مقابل صعود الصهيونية الدينية المتشددة
- تآكل الأيديولوجية الصهيونية
- الهاجس الأمني والعمق الجغرافي
- الانقسامات الداخلية بكل اشكالها السياسية والاجتماعية والعرقية
- تعطّل البنية السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية
- الهجرة المعاكسة
- تعاظم قوة المقاومة ووحدة ساحات المواجهة
- الاستنتاجات
مقدمة
الحديث عن أنّ ” دولة إسرائيل” ليس لها مستقبل للبقاء والاستمرار بدأ منذ 1987، أي مع انطلاقة الانتفاضة الفلسطينية الأولى، لكن الأبحاث العلمية والكلام الدقيق بدا في الخمس وعشرون سنة الأخيرة يأخذ أبعادا مختلفة حتى من الإسرائيليين أنفسهم. من ضمن هؤلاء، الحاخام ” ديفيد وايس الذي كان الناطق الرسمي باسم جماعة “ناطوري كارتا” التي تأسست سنة 1935، قبل اعلان قيام دولة الكيان في 1948. كان دور هذه الجماعة التي ينتمي اليها عدد من اليهود لا يزيد عن المليون، هدفهم الرئيسي عدم قيام دولة “لإسرائيل” لأنه في اعتقادهم كتب على اليهود ان يظلوا مشتتين الى ان تقوم الساعة. وأنّ أي محاولة لجمع اليهود في مكان واحد هي عصيان لأمر الله الذي حكم على اليهود بالشتات. ذكر الحاخام دفيد وايس هذا الكلام في سنة 2003، وأشار الى أنّ ” إسرائيل دولة ضد الله لأنها خالفت تعاليم التوراة في انّ اليهود يظلوا مشتتين في انحاء الأرض”.
انّ الظاهرة الصهيونية ظاهرة مركبة لها ابعاد كثيرة فقد ظهرت كفكرة في أوروبا في أواخر القرن السابع عشر، وتم بلورتها في منتصف القرن التاسع عشر، ثم ترجمت نفسها في البداية الى المنظمة الصهيونية العالمية في أواخر القرن التاسع عشر، ثم أخيرا الى الدولة الصهيونية في منتصف القرن العشرين. هذا الكيان صنع لنفسه “دولة توسعية” ضمت كل أراضي فلسطين، وقامت بغزو لبنان وظلت تحقق مشروعها العسكري حتى عام 1967، ثم بدأت تلحق بها الهزائم مع خروج الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000، والسقوط في “المستنقع اللبناني” على حد قول الصهاينة، وقد واجهت الصهيونية أشكالا مختلفة من المقاومة والردع منذ سنوات طويلة وصولا الى الان.
الصهيونية كحركة ودولة كان عليها التعامل مع جهات كثيرة: الاستعمار الغربي والدول الغربية كي تنتقل الصهيونية من نطاق الفكرة الى نطاق التطبيق. ثم يهود شرق أوروبا كي يمكن نقلهم الى ارض فلسطين ليشكلوا المادة البشرية الاستيطانية، ويهود العالم الغربي كي يقوموا بدعم المستوطن الصهيوني. اما بالنسبة للفلسطينيين، أصحاب الأرض التي طبق عليها المشروع الصهيوني فقد اعد لهم الصهاينة مخططا للإبادة والتنكيل والطرد، ولكن على الرغم من كل ما تمتلكه الة الحرب الصهيونية من أدوات لضرب دول المنطقة الا انها لم تنجح في كسر عزيمة شعوبها المحاصرة والمهددة من قبل الة الاستكبار العالمي خدمة للمشروع الصهيوني، وهي بالمقابل لا تزال متمسكة بالأرض والهوية.
منذ أكثر من سنتين بدأ الصراع السياسي داخل منظومة الكيان المؤقت في الانكشاف شيئا فشيئا، وبدأت تظهر علامات التفكك والتآكل والصراعات المستمرة. ولقد عززت خطة تقييد صلاحيات السلطة القضائية التي طرحتها حكومة نتنياهو الاستقطابَ السياسي في داخل الكيان، ودفعته نحو أزمة دستورية وسياسية، من شأنها أن تُعمِّق التصدع السياسي-الاجتماعي، بسبب تباين الرؤى حول هوية الدولة، وشكل نظامها السياسي.
من هذا المنطلق سنتعرض لتفاقم الازمة على المستوى السياسي واستمرارها (أولا) ثم نشير الى انهيار الكيان من الداخل ونتطرق الى مظاهر هذا الانهيار التي تشير حتما الى ان سقوط الكيان باتت مسالة وقت لا أكثر (ثانيا).
أوّلًا: تفاقُم الأزمة السياسية واستمرارها
منذ فوز اليمين في الانتخابات المبكرة الخامسة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، حظي بنيامين نتنياهو بفرصة تشكيل حكومته السادسة، ومنذ لحظاتها الأولى بدا أن لديها أجندة أيديولوجية سياسية حزبية، تمثّلت بتشجيع الاستيطان، وزيادة قمع الفلسطينيين، وتهويد المسجد الأقصى، وتغيير هوية الدولة، من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا، وتركيز السلطات بيد الحكومة، باعتبارها الجهة التنفيذية، على حساب السلطتين التشريعية والقضائية. هذا المخطط القانوني من شأنه، وفق المعارضة، أن يحوّل الكيان (الدولة المستعارة) تدريجياً لنظام شمولي دكتاتوري، ويضمن تبرئة نتنياهو من جرائم الفساد، وصبغ الكيان الصهيوني بتشريعات توراتية تلمودية، مما أثار غضب معظم الشارع الاسرائيلي ذو الميول العلمانية الليبرالية. أخذت هذه الإجراءات مجالها التنفيذي على الأرض فور تنصيب الحكومة أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2022، وتعيين ياريف ليفين وزيراً للقضاء،[ الذي شرع على الفور بإجراءاته القانونية مستعيناً بشركائه الوزراء، خصوصاً بتسلئيل سموتريتش وزير المالية، وإيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، وسيمحا روتمان رئيس اللجنة القانونية في الكنيست Knesset، وحظي جميعهم بدعم ملحوظ من نتنياهو ذاته.
في الوقت ذاته، أظهرت المعارضة (الخارجة للتوّ من هزيمة قاسية) إصراراً كبيراً على رفض الإجراءات القانونية، واعتبرتها انقلاباً على ما أسمته إعلان استقلال الدولة، مما دفعها لتحشيد صفوفها، ووصلت الاحتجاجات ذروتها بأبعادها الكمية والنوعية. واجهت الحكومة الإسرائيلية معارضة غير مسبوقة من عواصم غربية عديدة، لا سيّما من حلفائها الغربيين،خصوصاً واشنطن التي لم تخفِ مناصبتها العداء لحكومة الاحتلال منذ تشكيلها، واتخذت مواقف حدّية منها، وتصاعدت معارضتها لما عدّته انتهاكاً لمنظومة قيمهما المشتركة، وتهديداً لتشويه صورة الدولة في العالم، واعتبارها امتداداً لأنظمة عفا عليها الزمن. لقد شكّل التوتر الاسرائيلي الأمريكي سابقة خطيرة بتدهور علاقاتهما، عبر رفع الصوت القادم من واشنطن عالياً في انتقاد تل أبيب، مما مثّل ضغطاً حقيقياً على نتنياهو، وعلى رأسهم الرئيس جو بايدن وأقطاب إدارته، الذين أجّلوا دعوته لزيارة البيت الأبيض بعد ثلاثة أشهر على تشكيل حكومته، مما شكَّل له إهانة ضمنية.
أما العواصم الأوروبية فلم تتردد بإبداء تحفظها على الخطط الإسرائيلية، بالإضافة إلى مخططاتها القمعية بحق الفلسطينيين، وهو ما تجلى واضحاً في الزيارات المعدودة التي قام بها نتنياهو إلى برلين ولندن وروما وباريس، حيث لاحقته مظاهرات عارمة من قبل الأوروبيين والاسرائيليين المقيمين فيها. كلّ ذلك دفع نتنياهو لإعلان قراره بتأجيل إجراءاته القانونية، مما اعتُبر تراجعاً غير معهود عليه، وعلى الرغم من محاولته تسويق قراره بالحرص على “الكيان”، وعدم الانجرار لمزيد من الشروخ بين الإسرائيليين، لكن تداعيات ما اتخذه من قرار تنبئ بالأسواء حتما.
التغييرات القضائية المثيرة للجدل في مواجهة الأنظمة القضائية الغربية
يدعي بعض المراقبين الغربيين ان في كل ديمقراطية، تستمد الحكومات قوتها من الفوز في الانتخابات. من هذه النقطة المشتركة فصاعدًا، تكون الاختلافات عميقة: فما هي القيود، إن وجدت، التي تُفرض على قاعدة الأغلبية الصافية، وعلى العكس من السلطات القضائية التي تقيد تفضيلات الأغلبية؟ ما هي الضوابط والتوازنات التي تضمن الحكم الديمقراطي ولكنها تحمي حقوق الأقليات على قدم المساواة؟ طرح هذا السؤال في تجارب عديدة منها التجربة الامريكية والكندية والبريطانية ليتبين من خلال مراجعة سريعة لهذه التجارب، دور المحكمة العليا في هذه الأنظمة ومقارنتها بالنظام القضائي الاسرائيلي. ففي الولايات المتحدة مثلا، تكون القيود المفروضة على سلطة الأغلبية واسعة ورسمية (وليست مبنية على التقاليد أو القواعد غير المكتوبة). يتم تقسيم السلطة بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، وفي الحكومة الفيدرالية بين السلطات الثلاثة. يتم تحديد القواعد من خلال دستور مكتوب يتطلب موافقة ثلاثة أرباع الولايات وأغلبية الثلثين في مجلسي الكونجرس لتعديله. يمكن للرئيس استخدام حق النقض ضد التشريع ويتطلب تجاوز حق النقض تصويت ثلثي مجلسي الكونجرس. يمكن للمحكمة العليا إلغاء التشريعات باعتبارها غير دستورية، وحكمها نهائي، ولكن يتم اختيار القضاة أنفسهم من قبل الفروع السياسية: يتم ترشيحهم من قبل الرئيس ويحتاجون إلى موافقة مجلس الشيوخ. أمّا كندا، والتي لديها دستور مكتوب، على الرغم من أنه يستند بشكل صريح جزئيًا إلى الدستور البريطاني، الغير مكتوب. في كندا، يعين رئيس الوزراء قضاة المحكمة العليا، لكن يمكن للبرلمان الفيدرالي والهيئات التشريعية الإقليمية، عن طريق التصويت بالأغلبية البسيطة، تجاوز قرارات المحكمة العليا لعدد محدود من السنوات. بعد تلك الفترة الزمنية، يعود القرار حيز التنفيذ ما لم تقم الهيئة التشريعية بإيقافه مرة أخرى. وهذا ما يسمى “شرط الاستثناء” وهو القسم 33 من ميثاق الحقوق والحريات الكندي. كما وصف في مدونة Harvard Law Review، “من خلال إيجاد حل وسط بين أخطاء صنع القرار ذات الأغلبية والسلطات القضائية غير الخاضعة للمساءلة، فإن القسم 33 مهيئ ليحمي النظام من التجاوزات الأكثر خطورة. ” في المملكة المتحدة، حيث تم إنشاء محكمة عليا فقط في عام 2009، توصي لجنة اختيار مستقلة وزير العدل بالمرشحين للتعيين في المحكمة. بسبب السيادة البرلمانية، لا تتمتع المحكمة بصلاحية إلغاء القوانين التي أقرها البرلمان. يمكنها إعلان عدم توافق القوانين مع حقوق معينة للمواطنين، لكنها تظل سارية ما لم يتخذ البرلمان إجراءات في ذلك. يمكن للمحكمة أن تلغي بعض الإجراءات الرسمية، على سبيل المثال الإجراءات الإدارية من قبل الهيئات العامة، والحكم ضد الحكومة في القضايا الفردية.
أمّا في الكيان المؤقت، تعد المحكمة العليا، الشخصية الرئيسية في “الثورة الدستورية” الإسرائيلية التي وسع دور محكمتها العليا على يد أهارون باراك، الذي شغل منصب عضو المحكمة من عام 1978 إلى عام 1995، ورئيسًا لها من عام 1995 إلى عام 2006. أثناء وجوده في المحكمة، كتب باراك أن قاضي المحكمة العليا ليس مرآة، انه فنان يصنع الصورة بيديه. إنه “يشرِّع” – منخرطًا في “التشريع القضائي”، الإبداع القضائي وهو جزء من الوجود القانوني. مثل هذا الإبداع هو مهمة المحكمة العليا. يجادل النقاد بأن لغة مثل هذه توسع دور المحكمة على نطاق واسع للغاية. في مقالة مراجعة قانون عام 2011 حول باراك والمحكمة، خلص باحثان إسرائيليان إلى أن “تراجع التقدير العام للمحكمة العليا كان له علاقة كبيرة بتأكيد باراك على السلطة التقديرية القضائية. في نظر الجمهور، كان القضاة، الذين لم يتم انتخابهم من قبل الجمهور الإسرائيلي، يستخدمون السلطة التقديرية و “أجندتهم” الشخصية للتدخل في السياسات الدفاعية والاقتصادية لأذرع الحكومة المنتخبة – الكنيست ومجلس الوزراء” . كتب القاضي ريتشارد بوسنر، الذي خدم في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة السابعة، في عام 2007 أن “ما ابتكره باراك من القماش الكامل كان درجة من السلطة القضائية لم يحلم بها قضاة المحكمة العليا الأكثر عدوانية”. من هذا المنطلق تبدو البنية الدستورية في الكيان غير كاملة، وضعيفة. ومع ذلك، ليس فقط أن دولة الكيان المؤقت ليس لديها دستور، ولكن عدم وجوده تسبب في وضع حدّدت فيه المحكمة العليا في أحكامها – ولا تزال تحدد – الأجزاء المفقودة من هذا الهيكل، بينما أعطت لنفسها دورًا مركزيًا في البت في المسائل الدستورية. في هذا القانون، يتم استكمال الترتيب الدستوري، لكنه مصحوب بثمن باهظ: انتهاك حقيقي لمبدأ التمثيل.
هذه هي خلفية المعركة السياسية الشرسة في داخل الكيان اليوم حول جهود الائتلاف الحاكم الحالي لإجراء ما اسماه “إصلاح قضائي”. حثت العديد من الأصوات السياسية داخليا وخارجيا، على حل وسط يحافظ على دور المحكمة العليا في حماية حقوق الإنسان مع تقليص سلطاتها الإجمالية.
أسئلة كثيرة طرحها فشل الحكومة بفرض توجهاتها، على الرغم من حيازتها أغلبية برلمانية ذات 64 مقعداً في الكنيست، بجانب الشخصية القيادية لرئيسها، أمام تشتت رموز المعارضة، وعدم اتفاقهم على خطة محددة، لا سيّما يائير لابيد زعيم حزب “يوجد مستقبل (يش عتيد Yesh Atid)”، وأفيجدور ليبرمان زعيم حزب “إسرائيل بيتنا Yisrael Beitenu”، فيما أظهر الجنرال بني (بنيامين) غانتس زعيم “المعسكر الوطني” موقفاً وسطياً حافظ على تواجده في الجانبين، مما جعله أقرب لدعاة التسوية من المواجهة المفتوحة مع الحكومة. جاء فشل الحكومة على الرغم من الانحياز الإسرائيلي اللافت لتوجهاتها اليمينية بشقَّيها الديني والقومي، وتوفر أغلبية جماهيرية تمثَّلت بفوز لافت، لكن هذا اليمين بمختلف توجهاته ليس مجمعاً على المخطط القانوني الذي شرعت الحكومة بتنفيذه، لأن السواد الأعظم من أنصاره ذوو ميول علمانية ليبرالية، وعلى رأسهم نتنياهو ذاته، الذي وجد نفسه يقود هذا المخطط حفاظاً على نفسه من السجن، وليس لـ”تديين” الدولة، أو حكمها وفق شريعة التوراة.
وعلى الرغم من القبضة الحديدية التي انتهجها نتنياهو مع ائتلافه، لكنه فوجئ بتصدعات بجبهته الداخلية، خصوصاً في حزب الليكود، حيث صدرت أصوات معارضة لتحركاته، ولم يكن جالانت الحالة الوحيدة، فقد ألمح وزيرا الصناعة نير بركات والزراعة آفي ديختر ، ويولي أدلشتاين رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست بالموقف ذاته، وإن لم يكن بجرأة جالانت ذاتها. صحيح أن الحكومة أرجأت تنفيذ برنامجها القانوني، وشرعت بمفاوضات مع المعارضة لمحاولة التوصل لمسافة وسطى بينهما، لكن التقدير السائد أن الحكومة تستعد للتقدم بخطّتها بأدوات أخرى، للالتفاف على التسوية التي قدمها هيرتزوج، لكن الخلاصة هي ذاتها، وهو تقليص صلاحيات السلطة القضائية لصالح التنفيذية، وهنا يصبح من المتوقّع عودة المظاهرات من جديد، وبصورة أكثر زخماً وحدّة. أعاد ما حصل في الشهور الثلاثة الماضية من تطورات داخلية غير مسبوقة، طرح ما يراها الإسرائيليون “الخطة ب”، المتمثلة بإقالة الحكومة الحالية، المشكّلة بقيادة الليكود من أحزاب اليمين الفاشي مثل: الصهيونية الدينية، وعظمة يهودية (عوتسما يهوديت)، وشاس Shas، ويهود التوراة (يهودوت هتوراة)، واستبدالها بحكومة جديدة تتشكل من: الليكود، والمعسكر الوطني، وحزب العمل، ويوجد مستقبل”، وإسرائيل بيتنا”، لامتصاص غضب الشارع، وتهدئة التوتر مع واشنطن، التي أعلنت غير مرة رفضها لهذه التشكيلة الحكومية، ولم تتردد بإعلان رفضها استقبال عدد من وزرائها، خصوصاً إيتمار بن غفير وسموتريتش.
ضرب العلاقات الخارجية للكيان المؤقت
بالتأكيد ان استمرار الازمة وتفاقمها سيؤثر بشكل مباشر على علاقات الكيان داخليا وخارجيا، ومن الضروري الإشارة الى ان هذا الارباك الحاصل اليوم، لا يقف فقط عند مسالة القرارات او المشروع الذي اقترحه ناتنياهو وعمل على تنفيذه، انما هي تراكمات في الأخطاء والمشاكل والصراعات التي لن يقف تأثيرها عند موقف واحد من إصلاحات وغيرها، بل سيتعدى ذلك الى ما هو أخطر: ضرب الكيان في عيون حلفائه في الغرب والولايات المتحدة الامريكية.
العلاقة مع يهود الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ ينتمي معظم اليهود في الولايات المتحدة للتيار الإصلاحي والمحافظ في اليهودية، ويتبنون مواقف ليبرالية، ويصوت أغلبهم للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة. وقد عبّر اليهود في الولايات المتحدة عن قلقهم من التغيرات التي ستقوم بها الحكومة الإسرائيلية على المستوى الدستوري، والتي سوف تمس ما يعتبرونه نموذج “النظام الديمقراطي والقيم الليبرالية” التي يؤمن بها يهود الولايات المتحدة، ويترافق هذا الموقف المعارض لهذه التغييرات مع هيمنة المؤسسة والأحزاب الدينية الأرثوذكسية في الحكومة الذين يحاولون السيطرة على الحيز العام الإسرائيلي، والذين يعتبرون التيار الإصلاحي أو المحافظ في اليهودية تياراً معطوباً في يهوديته. وكان لافتاً للنظر تصريح أبراهام فوكسمان، الذي شغل منصب مدير عام الرابطة ضد التشهير (Anti-Defamation League) في الولايات المتحدة، الذي قال فيه إنه “إذا حصل سموتريتش وبن غفير على ما يريدون، فستخسر إسرائيل وكل يهود الولايات المتحدة”.
العلاقة مع الولايات المتحدة؛ فقد أعلنت الإدارة الأمريكية بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو أنها تتوقع من الأخيرة الحفاظ على القيم المشتركة بين البلدين، إذ تعتبر الولايات المتحدة هذه القيم جزءاً من توجهها لدعم الكيان في المحافل الدولية. وكان الكاتب اليهودي الأمريكي توماس فريدمان قد نشر مقالاً طالب فيه إدارة بايدن بالوقوف ضد إجراءات الحكومة الاسرائيلية، مُعتبراً أن بايدن هو الوحيد القادر على وقف هذه القرارات والإجراءات والتغييرات التي ستحدثها في نظامها السياسي، وإنقاذ إسرائيل من الحكومة المتطرفة فيها. وفي الواقع لن تتسرع الإدارة الأمريكية في تصعيد العلاقة مع الحكومة الجديدة قبل أن تتضح صورة التغييرات الدستورية التي ستنفذها الحكومة، وتداعياتها السياسية الداخلية على النظام وعلى الضفة الغربية، لا بل ستحاول التعاون مع نتنياهو ودفعه إلى منع إجراء تغييرات جوهرية في المبنى الدستوري الإسرائيلي.
العلاقة مع الاتحاد الأوروبي؛ إذ ستؤدي التغييرات الدستورية إلى توتر العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، ففضلاً عن المعارضة التي ستكون لدى دول أوروبية ضد التغييرات الدستورية لما تنطوي عليه من مسّ بحقوق المواطن والأقليات، فإن تلك التغييرات سوف تُقلل من التزام دول أوروبية بدعم الكيان في المؤسسات الدولية، وهنا كان لافتاً أن 27 دولة أوروبية وقّعت مؤخراً على بيان يُدين العقوبات التي فرضها الكيان المؤقت على السلطة الفلسطينية، ومنها دول عارضت أو امتنعت قبل ذلك على قرار الأمم المتحدة الذي طالب محكمة العدل الدولية بتقديم موقف قانوني حول الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وأهمها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. بالإضافة إلى ذلك، فإن منح الحكومة الإسرائيلية الحرية، من دون ضوابط دستورية، لمصادرة أراض فلسطينية خاصة، وهدم بيوت فلسطينية، وشرعنة البؤر الاستيطانية سوف يعمق التوتر والأزمة مع الاتحاد الأوروبي، حيث يعمل الأخير على دعم البناء الفلسطيني في مناطق (ج) في الضفة الغربية، وسيَعتبر هذه الإجراءات “اغتيالاً” مقصوداً لحل الدولتين.
المُساءلة القانونية في المؤسسات الدولية؛ ستؤثر التغييرات التي ستجريها الحكومة الإسرائيلية في مكانة الكيان الدولية من الناحية القانونية، فقد كانت استقلالية القضاء وسمعة المحكمة العليا الإسرائيلية دولياً، مانعاً أمام تبنّي إجراءات قضائية ضد الجنود والضباط الإسرائيليين في المحاكم الدولية، فقد كانت المؤسسات القضائية الدولية، وحتى المحلية في دول مختلفة، ترى أنه لا حاجة إلى محاسبة ومحاكمة ضباط الجيش الإسرائيلي بسبب وجود جهاز قضائي إسرائيلي مستقل “يحاسب” الجيش على انتهاكات يرتكبها خلال الحروب، أو في الضفة الغربية. وحرص الكيان على الحفاظ على خطوط حمر في تعامله مع العالم، ومنها الادعاء بأن الاحتلال مؤقت والحفاظ على مكانة المحكمة العليا، ومع تجاوز هذين الخطين فإن الكيان سيكون أكثر عُرضة لمساءلة القانون الدولي الذي لن يثق بالإجراءات القضائية الإسرائيلية، وبخاصة إذا شرّعت الحكومة القانون الذي يمنح الحماية للجنود الإسرائيليين من المساءلة القانونية ضد انتهاكات حقوق الإنسان وقوانين الحرب في الضفة الغربية وقطاع غزة.
العلاقة مع الفلسطينيين؛ ستؤثر التغيرات الدستورية في العلاقة مع الفلسطينيين، من حيث إنها سوف تزيل عن الحكومة كل رقابة أو مساءلة قانونية تتعلق بالممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بحيث تستطيع الحكومة اتخاذ قرارات متعلقة بالضفة الغربية تتضمن انتهاكات لحقوق الفلسطينيين دون أن تكون هناك إمكانية للجهاز القضائي أو المستشارين القضائيين لمنع هذه الإجراءات. فعلى سبيل المثال، ستتمكن الحكومة من مصادرة أراض خاصة للفلسطينيين بهدف الاستيطان، أو شرعنة بناء استيطاني على أراض خاصة، وذلك عبر قانون “التسوية” الذي حاول اليمين قبل سنوات تشريعه، والذي يهدف إلى تقنين استيلاء المستوطنين على أراض فلسطينية خاصة وبناء وحدات استيطانية عليها، وكانت المحكمة العليا قد ألغت هذا القانون في قرار لها في يونيو 2020، واعتبرته غير دستوري. علاوة على ذلك، ستُمكن التغييرات الدستورية من عدم محاسبة الجنود الإسرائيليين على انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني، وتشريع قوانين تعطي الحماية للجنود الإسرائيليين بصورة غير دستورية.
في ظلّ الحالة المربكة التي تواجهها الساحة الإسرائيلية، وتداخل العوامل الداخلية مع الخارجية، يصعب الخروج بسيناريو مرجح، بسبب كثرة اللاعبين، لكن سيناريو امكانية إعادة تشكيل الحكومة يبدو الأقل كلفة، خصوصاً في ضوء ما يواجهه الكيان من مخاطر أمنية وتهديدات عسكرية، قد تدفعه لتسكين جبهته الداخلية، والتفرغ لمواجهة التحديات الخارجية. مثل هذا السيناريو له العديد من الأقدام التي يسير عليها، أولها أن الفروقات بين الليكود وباقي معسكر اليمين والمركز لا تكاد تذكر في الموضوعات السياسية العامة، وثانيها أن هذا المعسكر يخشى، إن بقي في المعارضة، أن يتمكن اليمين الفاشي الحاكم من تغيير وجه الكيان كلياً، وثالثها أن هذا الخيار يحظى بتأييد واشنطن التي يتحرك سفيرها في تل أبيب توم نايدس بين الفرقاء الإسرائيليين لإيجاد صيغة توافقية. في المقابل، فإن مثل هذا السيناريو لن يكون معبّداً في ضوء مخاوف اليمين الحاكم من خسارة سلطته الحصرية، والتفريط بما يعدّها الفرصة التاريخية التي حظي بها في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وإمكانية أن يتسبب بانشقاق في صفوف الليكود، لا سيّما من عناصره الأكثر يمينية. مع العلم أن مثل هذا الخيار بحاجة الى ضمانات يبحث عنها نتنياهو، ولا يبدو أنه بوارد أن يتراجع عنها، وهو أن يضمن له الائتلاف القادم تبرئة ساحته من أي محاكمات تنتظره، وهو طلب لن يكون سهلاً تحقيقه لاعتبارات حزبية وقضائية.
(ثانيًا) انهيار الكيان المؤقت يبدأ من الداخل
يطرح السؤال حول المشكلات البنيوية في البيئة الأمنية والعسكرية للكيان، والتي قد تؤدي الى انهيار الكيان من الداخل؟ فما هي العوامل التي قد تساعد على ذلك؟ يذهب الاعتقاد الى وجود العديد من العوامل اهمها:
انهيار المؤسسة العسكرية: ازدياد ظاهرة الفرار من الخدمة العسكرية
كانت العسكرية الصهيونية قد نجحت في ان ترسخ في وجدان الاسرائيليين فكرة ان “اسرائيل” كيان صغير يدافع عن نفسه ضد هجمات الاعداء”، بل ان الايديولوجية الصهيونية تجعل اليهود شعبا مختارا بالمعنى الديني والعلماني، وتخلع القداسة على كل ممتلكات الدولة، وبخاصة حدودها، كما تخلع القداسة عن الجيش، حتى انه وصف بأنه القداسة بعينها. سابقا، وصف بنغر يون الجيش بأنه “مفسر التوراة، فمفسر التوراة هو وحده القادر على تعريف حدود إسرائيل”. من هذا المنطلق اكتسبت الخدمة العسكرية قداسة خاصة. الى جانب ذلك، كانت الخدمة العسكرية السبيل لدخول النخبة الحاكمة، ففي “المجتمع الاستيطاني”، لابد ان يدفع الفرد ضريبة ليصبح جديرا بالاشتراك في الحكم، وفي وضع القرار. ولذلك كان يتم تجنيد الشياب الإسرائيلي بنجاح شديد، عن طريق التوجه الى تحريك عواطفهم القومية والدينية، ورغبتهم في البقاء باعتبار ان الدفاع عن الذات رغبة إنسانية أخلاقية مشروعة، وباعتبار ان الشعوب المنطقة يهددون الوجود الإسرائيلي نفسه. غير ان الوضع قد تغير، وقد لوحظ فرار الشباب من المستوطنين الصهاينة من الخدمة العسكرية (إضافة الى رفض جماعات الحريديم الدينية للانخراط في الخدمة العسكرية، واعتبار ذلك من المحرمات وفقا لشريعتهم). في اخر استطلاعات الراي الإسرائيلية صرح العديد من الشباب الإسرائيلي انه إذا اتيحت لهم الفرصة لان يعفوا من الخدمة العسكرية الاجبارية التي تستغرق ثلاث سنوات، فلن يترددوا في فعل ذلك. بالمناسبة يعتمد الجيش الإسرائيلي على نظام الاحتياط، فيقوم باستدعاء جنود الاحتياط كل فترة لإعادة تأهيلهم. لذلك، تعتبر مشاركة جنود الاحتياط في الاحتجاجات الأخيرة الرافضة لقرارت حكومة ناتنياهو بمثابة الضربة المربكة لمنظومة الكيان الأمنية والعسكرية، نظرا لتأثير هذا الدور المتمرد في تغيير مسار خيارات مجموعات كبيرة داخل الجيش الإسرائيلي.
ان ظاهرة الفرار من الخدمة العسكرية والعزوف عنها، ظاهرة خطيرة في مجتمع استيطاني بني على أساس منطق القوة والتسلط والاعتداء على أصحاب الحق والأرض الأصليين، ولا شك ان هروبه من هذا الالتزام يسبب له مشاكل كثيرة في مواجهة علاقته بدول محور المقاومة. الملاحظ انه رغم خطورة القضية، لم يثر في المجتمع الإسرائيلي على نطاق واسع لأسباب عملية، منها أنّ الجيش الإسرائيلي يفضل ان يستبعد مثيري المشاكل وان لا تثار هذه القضية ولا تناقش امام الراي العام. لكن يبدو ان ما يحصل اليوم من تمرد مستمر ومن تصريحات من بعض جنود وضباط الاحتياط في مختلف الالوية العسكرية الإسرائيلية- الذين يدافعون عن مطالب المحتجين-سيزيد من حدة الوضع القائم، خصوصا امام عدم قدرة الجيش على تحييد المؤسسة العسكرية عن الصراع السياسي الحاصل حاليا.
سقوط نظرية الامن الإسرائيلية
في السابق، اقنعت المؤسسة العسكرية الصهيونية، الشباب الإسرائيلي، ان حربهم هي دفاع عن النفس، وانه لا خيار لهم في ذلك. لكن اثبتت نظرية الامن الإسرائيلية فشلها، فقد اقنعت الإسرائيلي، ان استعمال القوة سيحقق كل شيء. لكن بعد ان جرب العدو الصهيوني كل أنواع المواجهات مع المقاومة سواء في فلسطين او لبنان او غيرها، اقتنع ان استعمال القوة لا يحقق الامن، اذ وجد نسفه يتجرع الهزائم، ويقف اليوم في مواجهة ردع استراتيجي فرضته وحدة ساحات المقاومة في المنطقة، لتسقط بذلك رواية الامن الرادع أو المسيطر، ويصبح الإسرائيلي في مواجهة ” عقم الانتصار” كما اسماه المؤرخ الإسرائيلي يعقوب تالون.
زيادة معدلات العلمنة والعولمة والسعار الاستهلاكي في مقابل صعود الصهيونية الدينية المتشددة
بالتأكيد ان هذه الصورة المعقدة ستزيد من حالة التفكك والتآكل داخل المجتمع الاستيطاني الإسرائيلي، حيث اننا نقف امام جيل من المستهلكين الذي اعتنقوا شعار العولمة والعلمنة، وهو بالتأكيد امر لا يساعد كثيرا على تصعيد روح القتال والمواجهة مع “العدو”، وبالتالي هو يعزز أكثر فكرة العزوف عن الخدمة العسكرية. كما ان جو الخصخصة السائد في الكيان يزيد من تمركز الفرد حول نفسه، ويجعله يضع نفسه قبل المجتمع. وبالتالي انتشار التفكير المادي يخفف من فكرة الانتماء او الدفاع او الارتباط بالمكان، ذلك ان الأهم هو الرغبة المادية المجردة التي تخدم المصلحة الحينية والضيقة بعيدا عن شعارات التضحية والموت وتقديم الذات للمكان والأرض. حرص ناتنياهو على تثبيت اقدامه اعتمادا على حلفاء مغامرين وعديمي الخبرة الا من حقد واجرام وتحت مسميات متعددة ومختلفة بحق الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، وتبني سياسة تحريض ضدهم مع التخطيط لضربهم في كل مكان. ما يؤكد هذا الامر فعليا ما لاحظناه من تعليقات لبعض الأصوات الإسرائيلية التي حذرت من صعود اليمين الديني المتشدد ومن يمثله الى السلطة، وخاصم من تعيين كل من زعيم حزب “الصهيونية المتدينة” بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير. وقد نقل موقع “القناة السابعة”، عن رئيس الأركان السابق غادي إيزنكوت، قوله إن “تعيين بتسلئيل سموتريتش وزيراً للأمن وإيتمار بن غفير وزيراً للأمن الداخلي مقامرة”. وأضاف إيزنكوت أنّها “مقامرة ليس فقط لأنه خدم خدمة جزئية، بل لأنه (سموتريتش) يفتقد للخبرة أيضاً”، موضحاً أن سموتريتش “ليس لديه المعرفة الأساسية للتعامل مع التحديات الهائلة التي تواجهها المنظومة”. كما تابع: “إنني قلق جداً من هذين التعيين، أعتقد أن هذين الشخصين عديمي الخبرة وأيضاً لديهما وجهات نظر إشكالية، وإذا كانا يعتزمان تنفيذ ما التزموا به – فإن إسرائيل ستمر بوقت عصيب”.
تآكل الأيديولوجية الصهيونية
لم تعد الأيديولوجية الصهيونية الإطار الفكري الذي يفسر للمستوطنين واقعهم ويبرر وضعهم القتالي. باختصار شديد ان الأيديولوجية الصهيونية ما عاد لها مجال في المجتمع الصهيوني، ولم تعد الأجيال الجديدة الإسرائيلية تقتنع بها. من المفارقات التي تستحق التسجيل والملاحظة، ان هذا الجيل الجديد الذي يفر من الخدمة العسكرية ولا يكترث بها، هو جيل “أكثر عسكرية”، كما يقول افينيري شاليط أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية[1]، وقد ولد أعضاء هذا الجيل فيما يسمى “ارض إسرائيل” ولذا فهم يعتقدون تمام الاعتقاد ان الاحتلال بالقوة مسألة طبيعية، وان الضفة الغربية ليست ارض محتلة، وانما هي ارض قومية توراتية، ومن ثم فهي ارض متنازع عليها، وعلى اليهود الاحتفاظ بها، ولا يحق لهم التنازل عنها، او التفاوض بشأنها. اللافت في كل ذلك، أنه على مستوى السيادة السياسية، يضطر المستوطن الصهيوني-بسبب وضعه-الاعتماد على قوة خارجية تضمن له البقاء والاستمرار من خلال الدعم العسكري والسياسي المستمرين، وهو ما يفرغ مفهوم السيادة من مضمونه تماما. إضافة الى ذلك، يبدو المستوطن اليوم، شخصا استهلاكيا، ولم يتحول الى شخصية منتجة يعمل بيديه مثل الأجيال السابقة المؤسسة (التي تربت على ثقافة وتوجهات الكيبوتسينك المتقشف المحارب)، حيث ما نراه اليوم هو عبارة عن فشل أيديولوجي ولّد ما يسمى “أزمة المعنى”، والتي عادة ما تؤدي الى الإحساس بالعدمية وتجعل المستوطن ينكفئ على نفسه، ويبحث عن بقائه الشخصي، وعن خلاصه من خلال التوجه الحاد نحو الملذات. ظهر نوع جديد من المستوطنين الذين يبحثون عن الحراك الاجتماعي، وعن رفع مستوى معيشتهم، والبحث عن الرفاهية والأمركة المرتبطة تمام الارتباط بالعولمة التي لها نفس الأثر في التجمع الصهيوني. وعلى الرغم من ان هذه الظواهر موجودة في كل المجتمعات، ولكن أثرها السلبي أعمق في المجتمع الاستيطاني الصهيوني لأنه مجتمع يستند عقده الاجتماعي الى أيديولوجيا صهيونية تشكل الهوية اليهودية عصبها وعمودها الفقري.
الهاجس الأمني والعمق الجغرافي
سبب الهاجس الأمني، هو جبن الشخصية اليهودية عامة، وحرصها الشديد على الحياة الدنيا، مثل هذه الطروحات تفترض وحدة اليهود وانهم كيان مستقل عما حولهم، لكن ما نراه هو حالة انقسام تدعمها طبقية سياسية واجتماعية، ومشكلة هوية مع ازمة ديمغرافيا. لابد من الإشارة الى أنّ الهاجس الأمني لدى المستوطنين مصدره الخوف المستمر من السكان الأصليين أصحاب الأرض الحقيقيين، الذين لن يتنازلوا ولن يستسلموا عن مواجهة الاحتلال. حرص الكيان منذ نشأته وحتى الآن، على البقاء متفرّدا في كثير من المجالات، وسعى بكل السبل والوسائل لوضع نفسه في مرتبة متقدّمة عن باقي دول المنطقة وبفارق كبير، وكان على الدوام يعيش الهاجس الأمني بكل تفاصيله، ويعتقد- وما زال- أن معركته مع “أعدائه” من دول ومنظّمات وجماعات وحتى شعوب هي معركة وجود وليست معركة حدود، وأن الخطر المحدق به من كل جانب يستلزم منه أن يكون دائماً على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ، بل في كثير من الأحيان، يجب عليه المبادرة لوأد أي خطر يتهدد وجوده قبل أن يشتد عوده ويقوى ساعده. ولأنه كيان صغير جغرافياً، وذو عمق أمني ضعيف وهشّ، فقد عمل على خوض كل معاركه وحروبه بعيداً من حدوده الجغرافية، وسعى في المواجهات السابقة كلها، صغيرها وكبيرها، لمحاولة تجنيب جبهته الداخلية أي أضرار محتملة نتيجة تلك المعارك، بل كان على الدوام يعدّ استهداف “المدن الإسرائيلية” خطاً أحمر، ممنوع على أي جهة الاقتراب منه أو تجاوزه.
كل ما سبق عُدّ في فترة ما، ولا يزال، جزءاً أساسياً من نظرية “الأمن القومي الاسرائيلي”، التي وضعها ” ديفيد بن غوريون” في بداية الخمسينيات من القرن الماضي، والتي سعى كيان العدو من خلالها للتفرّد بمصادر القوة دون غيره من دول الإقليم، بما يمكنه من تنفيذ خططه العدوانية والتوسعية بشكل واسع. ومن هنا، فإن “الأمن القومي الإسرائيلي” يشمل مختلف مجالات النشاط والفعاليات الحيوية في الكيان الصهيوني، مثل القوة العسكرية، وبناء الذراع الضاربة للكيان وتطويرها وهي مؤسسة “الجيش”، ومشاركة كل المستوطنين فيه كجيش احتياط، والهجرة اليهودية إلى فلسطين، وتوسيع الاستيطان، وتخفيف الهجرة المعاكسة إلى الخارج، وتقوية القاعدة الاقتصادية، وتأمين تحرك سياسي دبلوماسي خارجي يُوظَّف لمصلحة تأمين متطلبات الأمن، إضافة إلى التربية والتعليم، وتمتين الجبهة الداخلية لتحقيق الأمن والمناعة القومية.
كذلك يمتد مفهوم “الأمن القومي الإسرائيلي”، ليشمل النشاط الأمني والعسكري خارج الرقعة الجغرافية لكيان الاحتلال، والتأثير في التفاعلات الإقليمية، بما يضمن التنبؤ بالتطورات التي يمكن أن تطرأ على القوى المحيطة، ومحاولة منعها من تحديد قدرات الكيان الصهيوني الجيو-سياسية أو التأثير فيها، على نحو يجعل تلك الدول تقبل به، وتتعامل معه كأمر واقع، لا يمكن تجاوزه أو تغييره. وينطلق هذا المفهوم من حقيقة أنّ الكيان الصهيوني يعيش في صراع وجودي، غير قابل للحل بالوسائل السياسية أو العسكرية، ولأن الواقع الأمني للكيان الصهيوني ضعيف ويتسم بالهشاشة وهوامشه ضيقة جداً بسبب انعدام العمق الاستراتيجي، فإن القيادة الإسرائيلية تمنح اعتبارات “الأمن العسكري”، قدراً كبيراً من الاستقلال الذاتي، وتعطي المؤسسة العسكرية حرية كبيرة في العمل، ما يمكّنها من استخدام كل ما تملكه من إمكانيات، لأغراض تتجاوز التحذير والإحباط والضربة الوقائية، وصولاً إلى تحقيق “الردع” الذي قامت عليه أساساً نظرية “الأمن القومي الإسرائيلي “.
ان الإحساس بالضياع قد تعمّق لدى الإسرائيلي، لا بسبب “تراثه الصهيوني”، وانما بسبب وضعه الاستيطاني، وهو وضع أودى به وأدخله في حروب مستمرة. ويبقى السؤال هنا، هل سينهار الكيان من الداخل؟ مع تعاظم التحدّيات الداخلية والخارجية، التي تواجهها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تتزايد حدّة التحذيرات من مختلف المستويات السياسية والعسكرية والإعلامية في الكيان، ومفادها أنّ “إسرائيل” تلفظ أنفاسها الأخيرة. فإلامَ استندت مخاوف قادة الاحتلال؟ وهل بات زوال “إسرائيل” قريباً؟
هناك اعتقاد راسخ لدى كثيرين من الإسرائيليين، مفاده أنّ عمر كيانهم لن يدوم أكثر من 80 عاماً – الأمر الذي يعني زوالها عام 2028 – انطلاقاً من وقائع تاريخية. فالكيانان اليهوديان السابقان (مملكة داوود، ومملكة الحشمونائيم)، لم يصمد أيّ منهما أكثر من 80 عاماً. وبالتالي، فإنّ كيانهم الثالث القائم حالياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة اقترب زواله، وفقاً للرواية اليهودية. هذا الأمر عبّر عنه، صراحة، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق، إيهود بارك، في مقال له في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، بالقول إنه “على مرِّ التاريخ اليهودي، لم تعمِّر لليهودِ دولةٌ أكثر من80 عاماً”. على رغم اعتقاد البعض أنّ إثارة هذه المخاوف تهدف إلى استعطاف اليهود تجاه الكيان الحالي، وضمان استمرار الدعم الغربي، فإنّ تزايد التحذيرات، على لسان قادة الاحتلال بشأن مصير كيانهم، يدفع إلى التساؤل إنّ بات زوال “إسرائيل” قريباً؟
الانقسامات الداخلية بكل اشكالها السياسية والاجتماعية والعرقية
لعلّ الانقسامات الداخلية، التي يعيشها الكيان المؤقت تشكّل أبرز التحديات التي تواجهها. وفي هذا السياق، يقول المحلل الإسرائيلي، جدعون ليفي: “إنَّنا نواجه أصعب شعبٍ في التَّاريخ. وعمليَّة التدمير الذاتي والمرض السرطاني الإسرائيلي بلغا مراحلهما النهائيَّة، ولا سبيل إلى العِلاج بالقبب الحديديَّة ولا بالأسوار ولا بالقنابل النوويَّة”.
تعطّل البنية السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية
- انهيار مؤسسة الكيبوتس، التي كانت تمثل العمود الفقري للمجتمع الاستيطاني الصهيوني، فمعظم أعضاء النخبة السياسية الحاكمة والثقافية كانوا من خريجيها. لكن الكيبوتس الان يعاني من أزمات كثيرة، وتغير طابعه العام، بل وفقد شيئا من طابعه الجماعي العسكري.
انتشار الفساد في المجتمع الاستيطاني الصهيوني.
- حالة التآكل في الحياة العائلية والتآكل الاسري مع تزايد معدلات العنف ضد الأطفال والشباب والنساء داخل المجتمع الاستيطاني الاسرائيلي.
- انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي (وقد رأينا كيف رفعت ولا تزال شعاراتهم في الاحتجاجات الأخيرة)، رغم ان اليهودية الحاخامية التقليدية تحرمه الا ان معظم المذاهب الدينية اليهودية المعاصرة، مثل اليهودية الإصلاحية والمحافظة، قد تقبلته وقننت له بل أنشأت مدارس دينية خاصة لتخريج الحاخامات الشواذ جنسيا.
الهجرة المعاكسة
تكثف الهجرة المعاكسة دليل على تغلغل اليأس في نفوس الإسرائيليين من مستقبل كيانهم، نتيجة فقدانهم للأمان، وعجز حكومتهم عن حمايتهم، فيزداد السعي للحصول على جوازات سفر أوروبية لمغادرة الأراضي المحتلّة عند توافر الفرصة الملائمة. ما عبّر عنه رئيس الكنيست السابق، إبراهام بورغ، في مقال له نُشر في “واشنطن بوست”، يصبّ في السياق ذاته، إذ قال “إنّ إسرائيل على أبواب نهاية الحلم الصهيونيّ، وتتجه نحو الخراب”. ودعا الإسرائيليين إلى امتلاك جواز سفر آخر، كما أوضح أنّه هو نفسه امتلك جواز سفر فرنسياً.
تعاظم قوة المقاومة ووحدة ساحات المواجهة
مع تعاظم قوة المقاومة في المنطقة، من فلسطين الى لبنان وسوريا واليمن والعراق، والصمود الشعبي، يرتفع منسوب الخوف الإسرائيلي من إمكان زوال كيانهم، وهو ما عبّر عنه غانتس، في قوله إنّ “المخاوف من سيطرة الفلسطينيين على “إسرائيل” في المستقبل ليست بعيدة عن الواقع، وإنَّ “الدولة اليهودية ستتقلَّص، خلال الأعوام المقبلة، لتصبح ما بين مستوطنة غديرا والخضيرة”. لقد شكّلت معركة “سيف القدس” عام 2021، نقطة تحوّل لمصلحة المقاومة، نظراً إلى تردداتها المدوية والمستمرة حتى اللحظة في الكيان الإسرائيلي المؤقت، في المستويين الرسمي والشعبي. تأكيدا لما تقدّم، يقول المحلل الإسرائيلي، غدغون ليفي، في صحيفة “هآرتس”، في ثالث أيام المعركة، إن “وجهتنا يجب أنْ تكون أوروبا، وعليهم أنْ يستقبلونا كلاجئين”. و لقد نجحت هذه المعركة في ضرب مفهوم الأمن القومي الإسرائيليّ، وأصبحت كلّ بقعة، باعترافٍ إسرائيلي رسمي، مستباحة وتحت مرمى صواريخ المقاومة من غزّة ومن حزب الله اللبنانيّ. كما أنّ ما يجري اليوم في الضفة الغربية، من تزايد العمل المقاوم، شكّل تهديداً استراتيجياً للكيان وفي هذا السياق، يعلّق المراسل العسكري في “القناة الـ 13” الإسرائيلية، ألون بن دافيد، على ما يحدث في الضفة خلال الأشهر الأخيرة، ويقول: “إنها انتفاضة من نوع آخر، تتباين عما شهدناه في الثمانينيات وعام 2000”.
الاستنتاجات
يرفض البعض القول بان المجتمع الاستيطاني اليهودي سينهار من الداخل بسبب الصراعات السياسية والدينية، او بسبب ضياع الهوية اليهودية، واستبداد التطرف الديني المتشدد الذي بدا يسطو على مجتمع استيطاني عمل منذ نشأته على ترسيخ بنية علمانية “ديمقراطية” بالمفهوم الغربي المعاصر. وحجة هؤلاء، أنّ مقومات حياة المجتمع الاستيطاني الصهيوني لا تنبع من داخله، بل من خارجه، فهو مدعوم ماليا وعسكريا وسياسيا من الولايات المتحدة الامريكية والغرب، إضافة الى الجماعات اليهودية المنتشرة في العالم، ولذا فهو لا يمكن ان ينهار من الداخل، لان هذا المجتمع الاستيطاني يمتلك أيضا اليات ومؤسسات يمكنها معالجة الاختلالات الموجودة وتخطي كل العقبات او التعقيدات والصراعات.
بالمقابل وتبعا للراي القائل بان انهار الكيان المؤقت بات قريب جدا، نظرا لخطورة الصراع اليوم على الكيان وبنيته السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. ونعتقد ان هناك العديد من العوامل التي ذكرت والتي تبدو كفيلة بالذهاب بهذا الكيان الى سدة الانهيار دون رجعة، خاصة ان هناك اعترافات كثيرة من أوساط صهيونية داخلية تؤكد ذلك. من هنا تبرز النقاط التالية:
- اعتبار التغييرات الجوهرية والدستورية المطروحة اليوم، والمس بمكونات النظام السياسي القائم منذ أكثر من سبعين عاما خطرا وجوديا قد يؤدي الى انهيار المؤسسات، وغياب الرقابة وتوغل الفساد وصراعات المحاصصة السياسية، والفردانية في الحكم، والتسلط في غياب مؤسسات رقابة قوية قادرة على الإمساك بكل خيوط اللعبة السياسية والقانونية كالمحكمة العليا.
- الصراع في الشارع الإسرائيلي بين المتمسكين بعلمانية النظام والدولة بما تحمل من قيم الحرية والديمقراطية الغربية، وبين توغل التوجه الديني المتطرف الأكثر تشددا والذي يعتبر من قبل العلمانيين، عامل تعطيل للبنيوية الحيوية للمجتمع الاستيطاني الصهيوني.
- توغل الطبقية السياسية والاجتماعية والعرقية داخل بنية المجتمع الاستيطاني الصهيوني: بين طبقة الاشكيناز المسيطرة على المال والمؤسسات وذات النفوذ القوي، والدور الكبير في صنع القرار الداخلي، وبين السفرديم، الطبقة الأكثر شعبية وفقرا واذلالا اجتماعيا، هذا الصراع دليل على تآكل الكيان من الداخل بكل تأكيد.
- ارتفاع منسوب الاجرام والعنف والتطرف وانتشار السلاح والمخدرات، يؤدي الى انهيار البنية المجتمعية الاستيطانية تدريجيا وتراكميا.
الأهم من كل النقاط المذكورة سابقا، هو اكتساب محور المقاومة في المنطقة لقدرات مادية وحيوية، مع تبني قوى هذا المحور لسياسة ردع استراتيجي، واستراتيجية هجومية-دفاعية قادرة على تغيير معادلات الردع التي وضعها الإسرائيلي لسنوات وأخفق في الحفاظ عليها. بالإضافة إلى ما سبق، فإنّ الانتصارات التي يحققها محور المقاومة في كل الجبهات، الداخلية والخارجية، وانتصاره في السنوات الاخيرة على “داعش”، وتعاظم قوّته العسكرية، وفرضه معادلات ردع جديدة، شكّلت جميعها تحديات تهدد وجود “الكيان المؤقت”، وهو ما يدركه قادة الاحتلال جيداً، لا بل ويتحدثون عنها علناً.