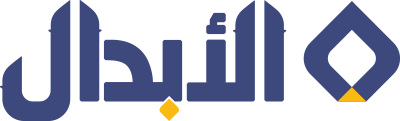التغيير

بسم الله الرحمن الرحيم
{إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ} الرعد: 11
{وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} سورة العصر
رسالة هذا الدين في حياة الإنسان هي (التغيير) و(الحركة)، وغاية هذه الحركة هي رضوان الله تعالى وقربه.
ومن خلال هذه (الحركة) يتكامل الإنسان ويبلغ نضجه ورشده.
وكمال الإنسان وسموّه بقدر ما ينال من قرب الله تعالى ورضوانه.
حقيقة التغيير
وحقيقة هذه الحركة تفعيل المواهب التي أودعها الله في نفس الإنسان، وبوسع الإنسان أن يفعّل هذه المواهب وينميّها، كما أن بإمكانه أن يميت هذه المواهب ويعدمها.
ومن هذه المواهب: المعرفة، واليقين، والإخلاص، والإيثار، والرحمة، والحلم، والشجاعة، والقوة، والعطاء، والتضحية، والصدق.
وكما يكمن في نواة التمرة كل خصائص النخلة، إلاّ أن الفلاح يفعّل هذه الخصائص الكامنة في النواة بإصلاح التربة وبالحرث والسقي والتشذيب والعناية، كذلك بوسع الإنسان أن يقوم بتفعيل ما أودع الله تعالى فيه من المواهب، وهذا التفعيل هو حركة الإنسان التكاملية إلى الله تعالى، وبعكسه سقوطه وفساده وخسرانه.
الخسران والفلاح في سورة العصر:
وليس للإنسان بين العروج إلى الله والفلاح، وبين السقوط والخسران حالة ثالثة.
فإمّا أن يكون في حالة الخسران والسقوط، وهي الحالة العامة التي عليها أكثر الناس على درجات مختلفة، وإمّا أن يكون في حالة الحركة والعروج إلى الله، وهي الحالة التي عليها قلّة من عباد الله.
وللأسف أن تكون الحالة الأُولى هي الحالة العامة والحالة الثانية هي الاستثناء.
وسورة (العصر) تبيّن هذه الحقائق جميعاً.
تبيّن أن الإنسان بين العروج والسقوط وليست بينهما حالة ثالثة ليس بالخسر، ولا بالفلاح، كما جاء في غير سورة (العصر).
يقول تعالى: {لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إِلاّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ}[1].
وتبيّن أن حالة السقوط والخسران هي الحالة العامة للإنسان {وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ} والعروج والكمال هي الحالة الاستثنائية في حياة الناس {إِلاّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ}.
وتبيّن حقيقة ثالثة هي أن توقّف الإنسان عن العروج سقوط، وعدم الربح خسران، فإنّ عمر الإنسان هو رأس مال الإنسان، وهو في حالة انقضاء وانصرام، وخسران دائم، وكل لحظة من العمر لا يستثمرها الإنسان في هذه الحركة الصاعدة إلى الله فقد خسر شطراً من الطريق، وفرصة من فرص الحركة والتكامل والتغيير، وهذا هو الخسران، ولذلك ورد في الحديث <من استوى يوماه فهو مغبون>[2].
عوائق التغيير:
ولهذا التغيير عوامل وعوائق، ولا يتم إلاّ من خلال هذه العوامل وإزالة هذه العوائق.
ومن هذه العوامل العقل، والإرادة، والفطرة، والضمير، ومن هذه العوائق الهوى الكامن في داخل النفس، والمغريات والفتن في ساحة حياة الإنسان، والشيطان، وهذا الأخير يسعى بين الأهواء والفتن، فيثير الأهواء تجاه الفتن، ويزيّن الفتن للأهواء، ويغري الإنسان بذلك ويضلّله ويوسوس في نفسه.
وقيمة التغيير في حياة الإنسان أنه يتم من خلال هذا المثلث الرهيب من العوائق (الأهواء والفتن والشيطان).
ولو لم تمر حركة التغيير من خلال هذا المثلث الصعب من العوائق، لم يكن للتغيير والتهذيب والتزكية في حياة الإنسان هذه القيمة.
الهوى والأنا
وتتم هذه الحركة التكاملية في حياة الإنسان باتجاهين:
1ـ تحرير الإنسان من (الهوى).
2ـ تحرير الإنسان من (الأنا).
والانا والهوى عائقان يعيقان الإنسان عن معرفة الله وطاعته.
سلطان الهوى:
وللهوى سلطان على الإنسان، يخرج الإنسان من دائرة عبودية الله إلى دائرة إتّباع الهوى.
ومن الناس من يطيع هواه، ويتبعها، كما لو كان إلهه هواه.
{أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً}[3].
{أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ}[4].
وهؤلاء تخرجهم أهواؤهم من دائرة (ولاية الله) وطاعته إلى دائرة (ولاية الشيطان) وإتباع الهوى.
وحركة الإنسان إلى الله بعكس هذا الاتجاه، تخرج الإنسان من دائرة نفوذ (الهوى) و(ولاية الشيطان)، وتدخله في دائرة ولاية الله، وتحرره من سلطان الهوى والشيطان، وتعبّده لله تعالى وأمره ونهيه.
ولست أعرف تعبيراً أبلغ عن الهوى ونفوذه وسلطانه على الإنسان من هذا التعبير المتكرر في القرآن {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ}.
حجاب الأنا:
هذا عن الهوى، أمّا (الأنا) فهو حجاب يحجب الإنسان عن الله. وكما تخرج الهوى الإنسان عن دائرة ولاية الله تعالى كذلك يحجبه (الأنا) عن معرفة الله، والنظر إلى أسمائه وصفاته الحسنى.
وبقدر ما يستغرق (الأنا) صاحبه، ويستقطب اهتماماته وسعيه وكدحه وفكره، ويشغل باله… يَحْرم الإنسان من النظر إلى وجه الله، ويحجبه عن الله.
وبقدر ما يتحرر الإنسان عن ذاته، ويتخلص من الاهتمام بها والانصراف إليها يتمكن من معرفة الله، وصفاته، وأسمائه الحسنى، والنظر إلى وجهه الكريم.
وهذا وذاك متوازنان متعادلان.
طغيان (الأنا) واستكباره:
وللانا في حياة الإنسان نحوان من البروز والظهور.
النحو الأول: الاستكبار والاستعلاء، والله تعالى يمقت الاستعلاء والاستكبار أشد المقت، يقول تعالى: {تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا}[5].
وهذا نحو من طغيان (الأنا)، وهو من الاستكبار الذي يذمّه الله في كتابه أشدّ الذم.
ومبدأ هذا الطغيان هو الانبهار بـ(الأنا) والإنشداد إليها والعجب بها، يقول تعالى: {إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى}[6]. وهذه الآية تحدد بالدقة العلاقة المباشرة بين الطغيان {إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى} ورؤية الذات والاستغراق فيها {أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى}.
وأول استكبار في التاريخ استكبار إبليس لعنه الله من أن يستجيب لأمر الله تعالى في السجود لآدم “ع”: {قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ}[7].
ومصيبة إبليس تتلخص في كلمة واحدة وهي «(أنا) خير منه»، ومصيبة فرعون تتلخص في نفس الكلمة فقال: «(أنا) ربكم الأعلى»[8]، و(الأنا) و(الاستكبار) مصدر أكثر مصائب الإنسان.
وطغيان (الأنا) من الاستكبار الذي يذمه الله تعالى في كتابه أشد الذم، ويمقته أشد المقت.
والاستكبار حجاب عن المعرفة من دون شك، وهو أساس الإعراض والصدود عن الله تعالى، يقول تعالى: {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلاّ اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ}[9].
وأساس العناد واللّجاج، يقول تعالى في وصف هؤلاء: {لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ}[10].
وأساس الاستنكاف عن عبادة الله، يقول تعالى: {وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيهِ جَمِيعًا}[11].
وعندما يتمادى المستكبرون في الغيّ يطبع الله على قلوبهم، يقول تعالى: {كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ}[12].
وإذا طبع الله على قلوبهم انغلقت عليهم أبواب الرحمة من السماء: {إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء}[13].
وبين انغلاق القلوب على الله وانغلاق السماء على القلوب علاقة وَصلة واضحة.
والنحو الآخر من ظهور الأنا في حياة الإنسان: أن يتحول الأنا إلى محور يستقطب كل اهتمام الإنسان وسعيه وكدحه وجهده وطموحه. فإنّ (الأنا) عندئذ يتحول إلى صنم يؤلّهه الإنسان من حيث يعلم أو لايعلم.
والقرآن الكريم يرفض محوريه الذّات رفضاً قاطعاً، ويلغيه، ويُثْبت في مقابله محورية الله تعالى في حياة الإنسان، والتي توضحه هذه الآية المباركة من سورة الأنعام: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}[14].
وإخلاص العمل لله، على هذا النهج، وتجريد العمل، بل الحب والبغض عن كل شوائب الذات هو المنهج الإسلامي الصحيح في علاقة الإنسان بالله، ويقع هذا المنهج في مقابل منهج محورية الأنا والذات.
كما أن تعميق حالة محورية الأنا في حياة الإنسان نحو من الشرك بالله، إلاّ أن هذا الشرك في العمل وليس في العقيدة، ومقابل الإخلاص وليس مقابل التوحيد.
وخلاصة الكلام أننا إذا أنعمنا النظر نجد أن سلوك الناس العملي والنفسي على نحوين:
النحو الأول من السلوك: هو أن تكون غاية الإنسان في عمله وحركته وكلامه وسكوته ومواقفه وحبه وبغضه هو الله تعالى، وأن يكون مرضاة الله هو المحور الذي يستقطب كل حياته وهو قوله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} وهذا هو الإخلاص لله تعالى.
والنحو الآخر من السلوك: هو أن يكون (الأنا) غاية الإنسان في كل اهتماماته، وطموحه، وسعيه، وينقلب الأنا في حياته إلى محور يستقطب كل اهتمامه وحركته. وهذا كما ذكرنا نحو من الشرك، غير أنه في السلوك وليس في العقيدة. ولكنه على كل حال من الشرك الذي يذمه الله تعالى.
| إذا قلت: ما أَذنبتُ. قالت مجيبة | (وجودك) ذنب لايقاس به ذنب |
و(الأنا) عندما يحتل هذا الموقع من نفس الإنسان ينقلب إلى حجاب يحجب الإنسان عن الله.
ومن الشعر الذي ينسب إلى بعض العارفين من أصحاب الذوق:
| بيني وبينك (إنّيي)[15] ينازعني | فارفع بلطفك (إنّيي) من البينِ |
التقوى علاج الهوى:
التقوى تخرج الإنسان من دائرة نفوذ (الهوى) و(ولاية الشيطان) وتدخله في دائرة (ولاية الله).
وهذه دائرة أمينة ومساحة محمية، لايدخلها الشيطان، فإنّ التقوى في حياة الإنسان حصن منيع يحمي الإنسان من نفوذ الهوى، وسلطان الشيطان.
يقول أميرالمؤمنين “ع”: <واعلموا عباد الله إن التقوى دار حصن عزيز، والفجور دار حصن ذليل،لا يمنع أهله، ولا يحرز من لجأ إليه>[16].
والعزيز: المقاوم، والحصن العزيز: الحصن المقاوم الذي يحمي من لجأ إليه من نفوذ العدو وسلطانه.
والتقوى حصن عزيز، لايقتحمه الشيطان ولكن يمسّ المتقين فيه مساً خفيفاً من بعيد، كأنه (طائف) يطوف بهم، فيتذكرون سريعاً، وبصورة مبكّرة، ويأخذون حِذرهم من الشيطان.
يقول تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ}[17].
هذا عن علاج الهوى وأمّا علاج (الأنا).
(الذكر) علاج الأنا:
وعلاج (الأنا)، (الذكر).
فإنّ (الأنا) يحجب الإنسان عن الله، والذكر يشدّ الإنسان بالله، ويفتح قلبه وعقله على الله، وبقدر ما يذكر الإنسان الله يتضاءل عنده الإحساس بالأنا، وبقدر ما تملأ المعرفة قلبه وعقله ومشاعره، يختفي الأنا في عقله وقلبه ونفسه.
وإذا انفتح قلب الإنسان على الله بالذكر، ولم تحجبه أنانيته عن الله تعالى يجد في ذكر الله لذة مجالسة الحبيب لحبيبه، وأُنس الحبيب بحبيبه، وقد ورد عن أميرالمؤمنين “ع”: <الذكر لذة المحبين>[18].
وعنه “ع” أيضاً: <الذكر مجالسة المحبوب>[19].
وعنه أيضاً: <ذاكر الله سبحانه مجالسه>[20].
وقال رجل للنبي “ص”: أحب أن أكون أخص الناس إلى الله تعالى، قال: <أكثر ذكر الله تكن أخص العباد إلى الله تعالى>[21].
وسر ذلك واضح لمن أنعم النظر في هذا الأمر، فإنّ الذكر يحرّر الإنسان من نفسه، ويشده بالله تعالى، ومهما كان هذا الشد والارتباط أقوى كان أخص بالله تعالى.
وقد ورد في الحديث القدسي: <إن موسى بن عمران “ع” ناجى ربه عزّوجل، قال: يارب أبعيد أنت مني، فأُناديك، أم قريب فأُناجيك؟
فأوحى الله جل جلاله: أنا جليس من ذكرني>[22].
وفي الحديث القدسي أيضاً:
<قال موسى: يارب أقريب أنت فأُناجيك؟ أم بعيد فأُناديك، فإِنّي أحس صوتك ولا أراك فأين أنت؟
فقال الله أنا خلفك، وأمامك، وعن يمينك، وعن شمالك. يا موسى أنا جليس عبدي حين يذكرني، وأنا معه إذا دعاني>[23].
وهذه غاية في القرب من الله تعالى، يحقّقها الذكر، ولا تتحقّق للإنسان هذه الدرجة من القرب إلاّ إذا كان قد انصرف عن نفسه وذاته إلى الله تعالى انصرافاً كاملا، عندئذ يجد في ذكر الله تعالى لذة لا تفوقه لذة حتى كأنه قد جالس الله ـ تعالى الله من أن يكون له جليس ـ وعندئذ يجد في أسماء الله وصفاته الحسنى من الجمال والجلال ما لايشبع منه ولايرتوي، مهما طال تفكيره وتأمله في الله تعالى وصفاته وأسمائه الحسنى.
الذكر والتقوى في وسط المجتمع:
ولاشكّ أن (الذكر) و(التقوى) قاعدتان لانطلاق الإنسان وعروجه إلى الله، ولايجد الإنسان إلى الله تعالى سلّماً أفضل من (الذكر) و(التقوى)[24].
وطبيعة الذكر تتطلب من الإنسان الابتعاد عن الناس والاعتزال، ليخلو الإنسان لله، ويتفرغ لذكر الله، فإنّ الحياة الاجتماعية وما فيها من المواقع والفتن تربة خصبة لنمو الأنا، وتعاظمه، ومهما ابتعد الإنسان عن الحياة الاجتماعية يكون أقدر على حماية نفسه من سلطان (الأنا).
كما أن طبيعة (التقوى) تتطلب من الإنسان الابتعاد عن الوسط الاجتماعي وما فيها من المغريات والفتن والمثيرات، فإنّ هذه الفتن من عوامل إِثارة الهوى وتهييجها، ومهما اعتزل الإنسان الحياة الاجتماعية يكون أقدر على حماية نفسه من سلطان الهوى ونفوذها.
ومن عجب أن الإسلام يأمرنا بمكافحة (الأنا) و(الهوى) ولكن من داخل الحياة الاجتماعية المليئة بالفتن والمغريات، وليس من خارجها وليس بالاعتزال والابتعاد عن الحياة الاجتماعية، كما هو الشأن في (الرهبانية) التي يرفضها القرآن الكريم بصراحة.
يقول تعالى: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ}[25].
والنصوص الإسلامية ترفض الرهبانية رفضاً قاطعاً وتعتبر الحياة الاجتماعية أصلا في هذا الدين.
روي أنه دخلت امرأة عثمان بن مظعون على عائشة ـ وكانت امرأة جميلةـ فقالت عائشة: ما لي أراك متعطّلة؟ فقالت: ولمن أتزين؟ فوالله ما قربني زوجي منذ كذا وكذا، فإنّه قد ترهّب، ولبس المسوح وزهد في الدنيا.
فلما دخل رسول الله “ص” أخبرته عائشة بذلك، فخرج فنادى: الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، فصعد المنبر فحمد الله، وأثنى عليه ثم قال: <ما بال أقوام يُحَرِّمون على أنفسهم الطيبات؟ أَلا إنّي أنام بالليل وأنكح وأفطر بالنهار، فمن رغب عن سنتي فليس مني>[26].
ودخل أميرالمؤمنين “ع” على العلاء بن زياد الحارثي يعوده، وهو من أصحابه فلما رأى سعة داره قال: <ماكنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا؟ أما أنت إليها في الآخرة أحوج، بلى إن شئت بلغت بها الآخرة تقري فيها الضيف، وتصل فيها الرحم فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة.
فقال العلاء: يا أميرالمؤمنين أشكو إليك أخي عاصم بن زياد.
قال: وماله؟
قال: لبس العباء، وتخلى عن الدنيا.
قال: عليَّ به، فلما جاء، قال: ياعدَيَّ نفسه، إِستهام بك الخبيث. أما رحمت أهلك وولدك، أترى الله أحلّ لك الطيبات، وهو يكره أن تأخذها، أنت أهون على الله من ذلك.
قال: يا أميرالمؤمنين هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك.
قال: ويحك إِني لست كأنت، إِن الله تعالى فرض على أئمة الحق أن يقدّروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره>[27].
إذن الإسلام يرفض الرهبانية رفضاً قاطعاً، وفي نفس الوقت يأمر الناس بمكافحة الأنا والهوى.
إن في الأمر لسراً، وان هذا السر من حقائق هذا الدين ومعارفه. فقد يتصور الإنسان لأول وهلة، وبالنظرة الأولى: إن (الرهبانية) واعتزال الناس هو العامل المفضّل للذكر والتقوى، وان الحياة الاجتماعية بما تحمل من المثيرات والمغريات والفتن من عوائق الذكر والتقوى.
ولكن بعض الإمعان والتأمل في معارف هذا الدين يكشف لنا عن وجه آخر لهذه القضية قد يغيب عن الإنسان ويكشفه (الوحي).
إن (الذكر) و(التقوى) هجرتان إلى الله من (الأنا) و(الهوى).
وقيمة (الذكر) و(التقوى) في هذه الهجرة، وعلى قدر مشقة هذه الهجرة تكون قيمة الذكر والتقوى.
ومهما كانت هذه الهجرة أشق على الإنسان، وكانت معاناته فيها أعظم كانت قيمة الذكر والتقوى أعظم.
ولأمر ما لا تبلغ قيمة الذكر والتقوى عند الملائكة ما تبلغه في حياة الإنسان، ولابُدّ لهذا الإيجاز من تفصيل وشرح، وإليك هذا الشرح.
الهجرتان:
إن الهجرة قد تتم في مساحة المجتمع وعلى وجه الأرض وقد تتم في داخل النفس.
والهجرة الأولى هي الهجرة الصغرى، ومنها هجرة الأنبياء “ع”، وهجرة المسلمين الأولى والثانية إلى الحبشة.
والهجرة الثانية داخل النفس وهي هجرتان: هجرة كبرى، وهجرة عظمى، كما يسمّيها علماء الأخلاق.
أمّا الكبرى فهي أن يهجر الإنسان في نفسه حب الظالمين وأعداء الله، ويهجر النزوع والميل إلى الشهوات والفتن التي حرمها الله تعالى على عباده، وهذه هي الهجرة من الأهواء والفتن، وتتم داخل النفس، وهي الهجرة الكبرى في مقابل الهجرة الصغرى التي شرحناها قبل قليل.
والهجرة العظمى، هي أن يهجر الإنسان ذاته التي بين جنبيه، ويخلص نفسه وعمله لله، ويتجرد من كل تعلقات (الأنا) وإعراضه، فيحبّ لله، ويبغض لله، ويعمل لله، ويهجر (الأنا) و(الأنانية) في حياته، وهذه هي الهجرة العظمى.
فإنّ (الأنا) هو الحجاب الأعظم بين الإنسان وبين الله تعالى ولا يحجب الإنسان عن الله شيء كما تحجبه ذاته وغروره وعجبه بنفسه واستعلاؤه واستكباره.
وهاتان هجرتان في حياة الإنسان إلى الله.
وعروج الإنسان إلى الله وقربه من الله تعالى يتم من خلال هاتين الهجرتين. ولا تتم هذه الهجرة وتلك، إِلاّ حينما ينتزع الإنسان نفسه من الفتن والأهواء والانا والذات انتزاعاً كاملا، وكلّما كان هذا الانتزاع أشق على الإنسان كانت هجرته إلى الله تعالى أبلغ وأعظم، وقربه من الله تعالى أكثر، حتى يكون{فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ}.
وقاعدة الإِنطلاق في هذه الهجرة النفسية هي الحياة الاجتماعية بما فيها من المثيرات والفتن والتقاطعات والتناقضات، وما يكتنفها من الشهوات والأهواء والحسد والطمع والاستكبار والاستعلاء، والأنانية، والعجب، والغرور.
ومن هذه القاعدة فقط ينطلق الإنسان من داخل نفسه ويهاجر من (الأنا) و(الهوى) إلى الله.
وأمّا إذا اعتزل الإنسان حياة الناس، وانكفأ على نفسه، ولم يدخل حياة الناس من أبوابها، ولم يتسلّم مسؤولية في حياة الناس، فلا يجد معاناة ولا مشقّة في هاتين الهجرتين، بل ليست له هجرة في الحقيقة إذا اعتزل الحياة الدنيا ومثيراتها ومغرياتها. وقيمة هذه الهجرة فيما يتلقاه الإنسان من المعاناة في انتزاع نفسه من الهوى والانا.
وهذا باب واسع من أبواب المعرفة في هذا الدين لا يسعنا الآن أن نتحدث عنه بأكثر من هذا الحد.
الذكر والتقوى في منهج العبادات:
و(الذكر) و(التقوى) أصلان في منهج التربية في الإسلام، ولكل منهما دور في إرتباط الإنسان وانشداده بالله تعالى، لا يغني أحدهما عن الآخر.
(الذكر) يمنح الإنسان المعرفة واليقين والإِحساس بحضور الله تعالى، ويفتح مغالق قلبه وعقله على الله، ويشعره بلذة النظر إلى وجه الله والتأمل في أسماء الله وصفاته الحسنى.
وتمنحه التقوى (الطاعة) و(الانقياد) و(التسليم) لله والدخول في دائرة (ولاية الله).
يمنحه (الذكر) الحب، والشوق، والأُنس بالله، ومعرفة الله، والخوف والخشية من الله، والمعرفة، واليقين بالله، والشكر، والحمد، والرجاء، والتوكل، والثقة بالله. ويمنحه (التقوى) الطاعة والتسليم والانقياد والعبودية، وبهذا وذاك يتكامل الإنسان ويعرج إلى الله.
ومنهج العبادات في الإسلام مصمم بشكل دقيق لتحقيق حالتي الذكر والتقوى في الإنسان.
فالصلاة ذكر، ذكر كلها من ركوعها وسجودها وأذكارها.
يقول تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي}[28].
والإكثار من الصلاة إكثار من الذكر، والإِستغراق في الصلاة استغراق في الذكر، والزكاة والصوم تقوى، والحج ذكر وتقوى، وهكذا نجد أن العبادات في الإسلام صممت من قبل الله تعالى بشكل دقيق ليتمكن الإنسان من التحرر من محوري (الأنا) و(الهوى)، ويرتبط الإنسان بالله من خلال (الذكر) و(التقوى)، فهما الجناحان الذين يعرج الإنسان بهما إلى الله تعالى.
التبادل بين الذكر والتقوى
ورغم أن لـ(الذكر) و(التقوى) دورين مختلفين في حياة الإنسان، فيختص كل منهما بمساحة متميزة من وعي الإنسان وخلقه وسلوكه… أقول رغم ذلك فإنّنا نجد في القرآن، وفي الأحاديث تبادلا في الأدوار بين الذكر والتقوى.
فيؤدي الذكر إلى التقوى، ويؤدي التقوى إلى الذكر، ويكون مردود كل منهما الآخر. وسوف نوضح هذا التبادل في الأدوار المتبادلة بين الذكر والتقوى فيما يلي:
علاقة الذكر بالتقوى:
فقد يكون مردود (الذكر): (التقوى) في حياة الإنسان، تأملّوا في هذه الآية المباركة من آل عمران: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}[29].
وواضح في هذه الآية أن نتيجة (الذكر) ومردوده التقوى.
تأمّلوا: {ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}
روي عن رسول الله “ص”: <إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا نسي التقم، فذالك الوسواس الخناس>[30].
وروي عن علي “ع”: <إن ذكر الله مطردة للشيطان>[31].
وعن أميرالمؤمنين “ع” أيضاً: <ذكر الله دعامة الإيمان، وعصمة من الشيطان>[32].
وروي أيضاً عن محمد الباقر “ع”: <ثلاث من أشد ما عمل العباد: إنصاف المرء من نفسه، ومواساة المرء أخاه، وذكر الله على كل حال، وهو أن يذكر الله عزّوجل عند المعصية، يهمّ بهما فيحول ذكر الله بينه وبين تلك المعصية. وهو قول الله عزّوجل: {إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ[33]}>[34].
وفي كتاب الله تصريح بهذه الحقيقة:
يقول تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ}[35].
والصلاة ذكر بغير ريب، يقول تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي}.
وهذا الذكر ينهي الإنسان، ويعصمه عن الفحشاء والمنكر، وهو العصمة والتقوى.
علاقة التقوى بالذكر:
والعكس أيضاً صحيح، فإنّ تقوى الله تعالى يمنح الإنسان البصيرة والمعرفة واليقين بالله، وهذه الأمور من خصائص الذكر، وتأتي هنا نتيجة للتقوى. يقول تعالى: {وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ}[36].
ويقول تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ}[37].
وهذا النور الذي يرزق الله تعالى عباده بالتقوى من خصائص الذكر.
ويقول تعالى في أمر يوسف “ع”: {وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ}[38].
والعلم والمعرفة من خصائص الذكر، ويأتي هنا نتيجة للتقوى.
وهذا هو ما ذكرناه من تبادل الأدوار بين الذكر والتقوى.
الذكر الجمعي:
وللذكر والدعاء الجمعي تأثير في الإِستجابة وترقيق القلوب، والانفتاح على الله تعالى، ما ليس في الذكر والدعاء المنفرد.
وأن القلوب لتستجيب لذكر الله تعالى، وتَرِقُّ في الذكر الجمعي أضعاف ما تستجيب وترق في حالات الانفراد.
وهذه النكتة من أسرار القلوب ومعارف هذا الدين.
وقد شرّع الله طائفة من الذكر على النهج الجمعي وفي وسط المجتمع ومن خلال الجماعة، كصلاة الجماعة وصلاة الجمعة والحج.
وإذا قمنا للصلاة بين يدي الله نقول{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} بصيغة الجمع، فإنّ صيغة الجمع أبلغ في العبودية والإِستعانة بالله تعالى.
وكذلك للتوبة والاستغفار الجمعي من التأثير في ترقيق القلوب والمغفرة ونزول الرحمة وارتفاع العذاب ما ليس في التوبة والاستغفار المنفردين.
وكان داود “ع” يخرج للدعاء والتضرع إلى البراري، فيخرج معه أربعة آلاف من الرهبان، يتضرعون، ويدعون، ويستغفرون معه، فإذا قرأ الزبور تجاوبت معه البراري والجبال والأشجار[39].
ومن الذكر الجمعي توبة قوم يونس “ع” بعد أن غضب عليهم نبيهم يونس “ع”، فدعا عليهم، فأقبل عليهم العذاب، فلما رأوا نزول العذاب رجع إليهم ما غاب عنهم من رشدهم، وندموا على ما فعلوا من العصيان والتمرد والصدِّ عن الله ورسوله، فدعاهم العبد الصالح العالم (روبيل) أن يرفعوا مجتمعين إستغاثتهم وإِنابتهم إلى الله تعالى، لعل الله أن يرد عنهم العذاب، فدفع الله عنهم العذاب، ولم يرد الله تعالى عن قوم استحقوه ونزل عليهم غير قوم يونس: {فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ آمَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخِزْيِ فِي الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ}[40].
تقول الرواية التاريخية[41] إن روبيل أشار على قوم يونس أن يخرجوا جميعاً إلى الوادي ويضجّوا إلى الله تعالى مجتمعين بالبكاء والصراخ، ويعزلوا الأطفال عن الأُمهات، ويستغيثوا بالله ويتضرعوا إليه ليدفع عنهم البلاء.
فعملوا بما أشار عليهم روبيل فردّ الله تعالى عنهم العذاب.
وليست هذه المظاهر التي أشار عليهم روبيل لاستعطاف الله تعالى، فإنّ الله رحمن رحيم شفيق، كريم، لايحتاج إلى مثل هذه الوسائل للاستعطاف والترقيق، ولكنها لترقيق القلوب التي قست بالمعاصي، فلا تنفتح على الله ولا تَرِقُّ في الدعاء، وعلاج هذه القلوب أمثال هذه المشاهد التي ترقّق القلوب القاسية، وتزيل عنها الرين والقسوة، فتتمكن عندئذ من قبول رحمة الله تعالى.
دور الليل والنهار في حياة الإنسان
ولكن، رغم صحة ما ذكرناه في الذكر والتقوى من التداخل والتبادل في الأوقات والأدوار… فإنّ بإمكاننا أن نقول إن الله تعالى جعل الحالة الغالبة للنهار العمل و(التقوى)، والحالة الغالبة للّيل (الذكر).
فقد جعل الله تعالى (النهار) في حياة الإنسان سعياً، وحركةً دائبةً، وهي تتطلب من الإنسان (التقوى)، ومراعاة حدود الله بدقّة.
وجعل الله سكون الليل فرصة للذكر والتبتل والمناجاة والدعاء والقيام بين يدي الله.
ويتكامل الإنسان تكاملا سوياً في الليل والنهار.
دور الليل والنهار في سورة (المزمّل):
إنّ قراءة متأملة لسورة (المزمّل) تثبت هذه الحقيقة يقول تعالى: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلاّ قَلِيلاً * نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً * إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً * إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلاً * إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلاً * وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً}[42].
والله سبحانه يأمر رسوله في هذه الآيات أن يعد نفسه لأَمرين عظيمين: للقول الثقيل الذي ينزل عليه من عند الله، وينهض به بأمر الله تعالى في الناس، وهو كلمة التوحيد والدعوة إلى الله {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً}، ولما تتطلبه هذه الكلمة وهذه الدعوة من حركة واسعة في المجتمع.
ولكي ينهض رسول الله “ص” برسالة التوحيد في حياة الناس، ويُعِدُّ نفسه لها يأمره الله تعالى أن ينظم وقته في الليل والنهار، ويوزع جهده وهمه بينهما.
فيتفرغ في الليل للقيام بين يدي الله والذكر والتبتل، ويُرَتِّل القرآن ترتيلا. ففي سكون الليل ينفتح القلب على الله تعالى ويجد الإنسان في نفسه من الإِقبال على الله ما لا يجده في النهار، ويرتوي قلبه وعقله بالقرآن أضعاف ما يستطيع أن يأخذ من القرآن في النهار، ويجد في نفسه الأُنس والشوق والسكون والتعلق بالله ما لا يجده في النهار.
فإنّ {نَاشِئَةَ اللَّيْلِ} ـ وهي ما ينشؤه الإنسان في ساعات الليل من الذكر والصلاة وترتيل القرآن ـ هي أثبت لقلب الإنسان و{أَشَدُّ وَطْءًا} وأقوم لمنطقه وحجته.
ولذلك يأمر الله تعالى رسوله “ص” أن يتفرغ في الليل للقيام والذكر وترتيل القرآن، ليُعدَّ نفسه لاستقبال القول الثقيل والقيام به في الناس، وليُعدَّ نفسه لما تتطلبه رسالة التوحيد والدعوة إلى الله من حركة واسعة وتقلب في النهار في المجتمع {إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلاً}.
وهذا السبح الطويل والتقلّب الواسع للقيام بهذا القول الثقيل في النهار… يتطلب من رسول الله “ص” أن يعد نفسه إعداداً صعباً في سكون الليل، ليوطّيء قلبه وقدمه، وليقوّم منطقه وحجته {هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلاً} للقيام بهذه الرسالة في المجتمع.
وهذا هو المنهج القرآني القويم في توزيع جهد الإنسان وعمله في الليل والنهار، وينظّم دور الليل والنهار في حياته بصورة صحيحة.
دولة الليل ودولة النهار:
وللّيل أبطال ودولة، وللنهار أبطال ودولة. ودولة الليل في التضرع والاستكانة إلى الله والدعاء والمناجاة والذكر والخشوع والتبتل والإنابة والتوبة.
ودولة النهار في الجد والعزم والسعي والكدح والجهاد والتقوى والعفاف و…
وكل منهما دولة. ولكل دولة رجال وأبطال.
ومن الناس من يكون من أبطال الليل، وليس من أبطال النهار. فإذا جاء الليل نشط للعبادة والتضرع والبكاء والاستكانة، واحتفت به ملائكة الله تسمع مناجاته ودعاءه، وتشتاق إلى حنينه وبكائه وإخباته وتبتله بين يدي الله. فإذا جاء النهار خَمَلَ واعتزل الناس، حتى لا يسلبه النهار ما اكتسبه في خلوة الليل… أُولئك أصحاب دولة الليل، فهنيئاً لهم وطوبى.
ومن الناس من يكون من أبطال النهار في العزم، والجد، والكدح، والتقوى، والإخلاص، فإذا حلَّ به الليل أخلد إلى النوم وسلّم للنوم جوارحه وجوانحه تسليماً.
والنوم في حياة الإنسان حاجة كسائر حاجاته الطبيعية، يأخذ فيه المؤمن ما يحتاجه منه دون أن يستسلم له.
فإنّ المؤمن إذا اقتصر من النوم على حاجته تحكّم هو في النوم، وإذا سَلَّم له جوارحه وجوانحه تحكّم النوم فيه.
وهؤلاء هم النمط الثاني من الناس.
والنمط الثالث من الناس الذين آتاهم الله تعالى دولة الليل والنهار معاً، وهم أقل من القليل، وصفوة الصفوة من عباد الله، ولا يتكامل الإنسان حق الكمال، ولا يبلغ ذروة التقوى والصلاح والمعرفة والذكر إلاّ عندما يجمع الله تعالى له بين دولة الليل والنهار.
يقول أميرالمؤمنين “ع” عن هؤلاء في خطبة المتقين المعروفة بخطبة همّام: <أمّا الليل فصافون أقدامهم، تالين لأجزاء القرآن يرتّلونها ترتيلا، يُحزَنِّونَ به أنفسهم، ويستثيرون دواء دائهم، فإِذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً، وتطلعت نفوسهم إليها شوقاً، وظنوا أنها نصب أعينهم، وإذا مرّوا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم، فظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم، فهم حانون على أوساطهم، مفترشين لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم، يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم. وأمّا النهار فحلماء، علماء، أبرار، أتقياء، قد براهم الخوف بري القداح، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى، وما بالقوم من مرض ويقول لقد خولطوا، ولقد خالطهم أمر عظيم>[43].
أقرأ ايضاً:
المصادر والمراجع
- [1] ـ التين: 4 ـ 6.
- [2] ـ بحار الأنوار 68: 173.
- [3] ـ الفرقان: 43.
- [4] ـ الجاثية: 23.
- [5] ـ القصص: 83.
- [6] ـ العلق: 6 ـ 7.
- [7] ـ سورة ص: 76.
- [8] ـ {فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى} النازعات: 24.
- [9] ـ الصافّات: 35.
- [10] ـ المنافقون: 5.
- [11] ـ النساء: 172.
- [12] ـ غافر: 35.
- [13] ـ الأعراف: 40.
- [14] ـ الأنعام: 161 ـ 163.
- [15] ـ إنّيّي يعني أنانيتي، وهي مشتقة من: إنّي.
- [16] ـ نهج البلاغة، خطبة 157.
- [17] ـ الأعراف: 201.
- [18] ـ غرر الحكم للآمدي: 670.
- [19] ـ غرر الحكم: 322.
- [20] ـ غرر الحكم: 5159.
- [21] ـ كنز العمال للمتقي الهندي 16: 128 ح44154.
- [22] ـ بحار الأنوار 93: 153.
- [23] ـ كنز العمال 1: 433 ح1871.
- [24] ـ الابتلاء سلّم من دون شك، ولكن الابتلاء يذكّر بالله ويؤدي بالإنسان إلى التضرع بين يدي الله فهو يُعِدُّ الإنسان لذكر الله.
- [25] ـ الحديد: 27.
- [26] ـ بحار الانوار70: 116.
- [27] ـ نهج البلاغة، الخطبة 209.
- [28] ـ طه: 14.
- [29] ـ آل عمران: 135.
- [30] ـ تفسير الثقلين 5: 735.
- [31] ـ غرر الحكم: 5162.
- [32] ـ المصدر السابق.
- [33] ـ الأعراف: 201.
- [34] ـ بحار الأنوار 66: 379 ح 36.
- [35] ـ العنكبوت: 45.
- [36] ـ البقرة: 282.
- [37] ـ الحديد: 28.
- [38] ـ يوسف: 22.
- [39] ـ بحار الأنوار 14: 17.
- [40] ـ يونس: 98.
- [41] ـ راجع بحار الأنوار14: 381 باب 26 ح1.
- [42] ـ المزمّل: 1 ـ 8.
- [43] ـ نهج البلاغة 2: 162 خطبة193.